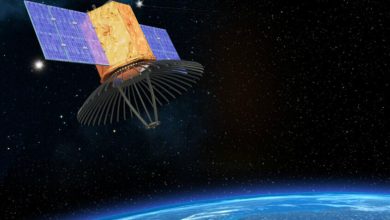محمد بن سلمان لواشنطن: موسكو تنتظرنا

بقلم -حسين إبراهيم كاتب صحفي لبناني
للرئيس المصري الأسبق حسني مبارك مقولة مشهورة أتى بها قبل وقت طويل من سقوطه، وهي أن “المتغطّي بالأميركان عريان”. قد يكون السعوديون في السنوات الأخيرة، أكثر مَن اختبر هذه المقولة.
وفي ظلّ المتغيّر الكبير المتمثّل في الهروب الأميركي من أفغانستان، ربّما أراد محمد بن سلمان تجربة مدى استعداد واشنطن للدفاع عن النظام السعودي في وجه المخاطر الداخلية والخارجية، وفي الوقت نفسه محاولة استغلال هذه الفوضى لتحقيق هدفه الدائم في نيل مباركة أميركية لاعتلائه العرش، فأرسل شقيقه خالد نائب وزير الدفاع إلى موسكو لتوقيع اتّفاق تعاون عسكري مع الروس، يُنظر إليه على أنه تلويح لأميركا بوجود بدائل لديه
عندما خرج السوفيات من أفغانستان في عام 1989، احتفلت السعودية بانتصار الحلف الأميركي عليهم. وكان لها “الحق” في أن تفعل، لما كان لها من مساهمة حاسمة في ذلك، عبر إرسال “المجاهدين” وتمويل الحرب. الآن، وبعد أن دارت الدورة على الأميركي ليهرب هو نفسه من البلد الطارد للغزاة بطبيعته، على حدّ وصف جو بايدن، يمّمت الرياض وجهها مجدّداً شطر موسكو، لتستنجد بعدوّها القديم، وتُوقّع معه اتفاق تعاون عسكري، تعمّد الجانبان عدم الإعلان عن تفاصيله.
منذ زمن، قرّرت الرياض إقامة علاقة صداقة مع موسكو وغيرها، مِمّن كانت تعتبرهم في الماضي أعداء، أو كانت مجبرة على ذلك، بعد حرب أفغانستان في الثمانينيات وغيرها من الحروب المموَّلة سعودياً على السوفيات ثمّ الروس، بما فيها حرب الشيشان. وتزامن التوجّه السعودي الجديد مع تراجع تدريجي في الاهتمام الأميركي بالسعودية.
لكن تلك العلاقة ظلّت محدودة وذات وظائف معينة، أهمّها التلويح للأميركيين بوجود بدائل، رغم إدراك الرياض سلفاً أن طبيعة ارتهانها للأميركي تجعل القرار بيده تماماً. كما كان من بين الوظائف المذكورة تعويض النقص في مشتريات السلاح بسبب سياسات غربية صارت تفرض حظراً جزئياً أو كلّياً على بيع السلاح للمملكة، من قِبَل دول ككندا وألمانيا وبلجيكا وغيرها.
لكن تعويض نقص السلاح نفسه يواجه خطوطاً حمراء أميركية، فعلى رغم إعداد صفقة لشراء منظومات صواريخ أرض – جو “أس – 400” في عام 2018 بين السعودية وروسيا، إلا أنه لم يُسمع عنها شيء مذّاك، بالنظر إلى ما تثيره الصواريخ المذكورة من حساسية خاصة لدى الأميركيين بتبعاتها الخطيرة على مبيعات صواريخ “الباتريوت” والطائرات الحربية الأميركية.
وعليه، ليس من المتوقّع أن تَخرج أيّ مشتريات أسلحة روسية محتملة من جانب السعودية عن السقف الأميركي، على رغم أن العلاقات السعودية – الأميركية هي حالياً في واحد من أدنى مستوياتها التاريخية. لو كان الأمر عائداً إلى السعوديين لأوجدوا بدائل للحماية الأميركية أو متمّمات لها، أمس قبل اليوم.
لكن أميركا تُمسك برقاب القائمين على النظام السعودي، ولن تدعهم يذهبون إلى أيّ مكان، حتى لو أرادت الانسحاب عسكرياً من الخليج. فالعلاقة بنيوية إلى درجة يكاد التحلّل منها يكون مستحيلاً.
والسلاح السعودي، مثلاً، أميركي بنسبة تزيد عن ثمانين في المئة، وأيّ محاولة حقيقية لتنويع مصادره ستُعتبر لعباً بالنار. وإذا حصلت، فستكون جزئية ومحدودة. إلّا أنه مع ذلك، ثمّة مخاوف أميركية من استغلال روسيا والصين أيّ ثغرة للحصول على قطعة أكبر من كعكة صفقات السلاح.
مشكلة ابن سلمان أنه ما زال يدور في الحلقة نفسها، منذ تولّي جو بايدن الرئاسة. هو يريد الاطمئنان إلى أن إدارة بايدن ستَقبل به ملكاً، فيما هي ترفض حتى إسقاط القضايا القانونية التي تطاوله في الولايات المتحدة، والتي يمكن أن تشهد تطورات في الأسابيع المقبلة، مِن مِثل أن يضاف إليها الكشف عن وثائق 11 سبتمبر/أيلول التي تُورّط الرياض في هجمات نيويورك وواشنطن في عام 2001، مع خطر تدفيع المملكة تعويضات ضخمة لأسر 3000 قتيل.
يدرك ولي العهد أن أميركا لا تمتنع فقط حتى الآن عن دعمه شخصياً، وإنما أيضاً قد لا تكون جاهزة للدفاع عن النظام كلّه، خاصة في مواجهة تهديدات داخلية، حتى لو كانت مفتوحة على تهديدات خارجية، كتهديد حركات الإسلام السياسي، أو تهديد معارضين من داخل الأسرة المالكة لولي العهد الذي صعد إلى السلطة بدعم من الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، ثمّ وجد نفسه بعد خسارة الأخير الانتخابات أمام حقائق جديدة غير مريحة تتمثّل في بيئة أميركية معادية للممكلة، وله شخصياً، لا تنفكّ تزداد عداءً منذ هجمات 11 سبتمبر/ أيلول.
الكلام عن “التنويع” حضر في مقابلة ابن سلمان التلفزيونية الأخيرة في نيسان الماضي، والتي قال خلالها إن الولايات المتحدة لم تَعُد بالقوة التي كانت عليها سابقاً، وإن قوتها تعود جزئياً إلى المال السعودي الذي حصلت عليه عبر السنين.
ورغم أنه ليس واقعيا انتظار أن تزداد كثيراً حصّة الروس أو الصينيين من العلاقات العسكرية مع السعودية، فإن للمملكة مصالح كبيرة مع كلّ من موسكو وبكين، من بين أهمّها أنها تستطيع بالاتفاق مع روسيا التحكّم بأسعار النفط، بوصفهما من أكبر المنتجين له في العالم، في حين أن الصين صارت تنافس أميركا في كلّ الأسواق، بما فيها الخليجية.
أمّا حكاية الدفاع عن النظام السعودي أو عن ابن سلمان من تهديدات من داخل النظام، فهي مسألة تخصّ الأميركيين وحدهم، وليس مطروحاً أن يدخل عليها أيّ طرف آخر، إلّا إسرائيل، وبموافقة أميركية وسعودية.
وإذا كان الأميركيون يريدون حقاً تنفيذ انسحاب ما من الشرق الأوسط يترك فراغات أمنية، فالأمر سيتوقّف على شكل الانسحاب وحجمه والترتيبات التي سترافقه، مِن مِثل العودة إلى الاتفاق النووي مع إيران، والذي ربّما يسمح بترتيبات تشمل العلاقات بين دول المنطقة. ما هو أكيد أن الأميركيين يريدون التخفّف من الكثير من الأعباء المكلفة، مِن مِثل حماية هذا النظام أو ذاك.
كان يمكن للإفصاح عن ماهية الاتفاق السعودي مع الروس في شأن نوعية الأسلحة المشمولة فيه وثمنها والمعاهدات الأمنية المرافقة له – إذا ما وجدت -، أن يجيب على الكثير من الأسئلة. لكن الإعلان عن الاتفاق، بحدّ ذاته، في هذا التوقيت، لا يمكن إلا أن يكون رسالة إلى الأميركيين، بهدف تحريك الملفّات العالقة معهم.
وخاصة أن خالد بن سلمان نفسه كان قد قام بزيارة لواشنطن في الأسبوع الأول من تموز الماضي، اعتُبرت في حينه “بدلاً من ضائع” لزيارة ولي العهد غير المرغوب به في البيت الأبيض، فيما بدا أنها لم تنجز الكثير.
وسواءً كانت ثمّة رغبة حقيقية في تنويع العلاقات أو مجرّد نيّة توجيه تحذير إلى الأميركيين، فإن محمد بن سلمان يستفيد من كون الولايات المتحدة، بدورها، صارت بلداً مكروهاً من قِبَل غالبية السعوديين. وهذا ما أظهرته حفاوة سعوديين كثر على وسائل التواصل الاجتماعي بالاتفاق السعودي – الروسي، باعتبار أن “العالم يتّجه شرقاً”، على حدّ وصف أحدهم.
يبقى البازار السعودي، في كلّ الأحوال، مفتوحاً أمام تحالفات جديدة على الطريقة التي لا يعرف الخليجيون غيرها، وهي شراء الحماية بالمال.